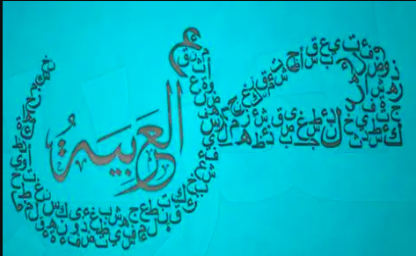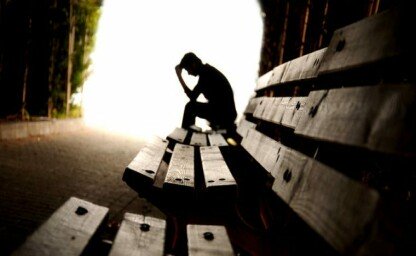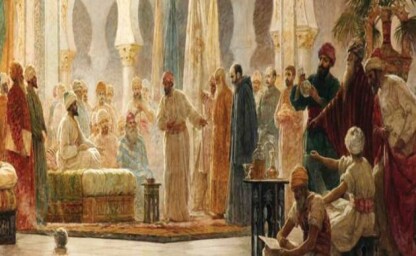
يوم حنين
حين أصاب رسول الله ﷺ الغنائمَ يوم حنين وقسم للمؤلفة قلوبهم من قريش وسائر العرب ما قسم ولم يكن في الأنصار منها نصيب؛ وجد بعض الأنصار في أنفسهم وقال قائلهم: لقي والله رسولُ الله قومَه أي ترككم وعاد إلى قومه..
عندها جاء سيدنا سعد بن عبادة رضي عنه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إنّ هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم
فقال النبي: فيم؟
قال: فيم كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
هنا قال سيدنا سعد كلمة عجيبة..
ما أنا إلا امرؤ من قومي
تأمل الكلمة جيدا...
من قومه!
وسيدنا سعد رضي الله عنه كان أنصاريا خزرجيا
يعني من نفس قومه - الخزرج = عبد الله بن أُبي بن سلول؛ رأس النفاق!
رغم ذلك أطلقها سيدنا سعد مبينا عدم مخالفته لقومه في هذا الموقف
لم يستثن سيدنا سعد مثلا فقال من قومي عدا بن سلول
أو عدا المنافقين من قومي
لم يقل شيئا من هذا
رغم ذلك وحين جمع النبي ﷺ قومه وخطب فيهم خطبته العظيمة التي أبكتهم وقالوا في إثرها رضينا برسول الله قسمًا لم تشتمل خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة قيام سعد رضي الله عنه باحتراز في مقولته أو بيان لها
لماذا؟
ببساطة لأن وجود قرينة ظاهرة في محل ما = كفيل بأن يحمل مقصود الكلام على هذه القرينة
وسواس التقييد والاستثناء
أما هذه الحساسية المفرطة تجاه الكلام وإطلاقه وتعميمه والتي صارت مؤخرا تعد من السمات الحالية لدى كثير من المنتسبين للتدين فلا أدري بصدق من أين جاءوا بها
من أين استمدوا تلك الفكرة التي تسيطر على كثير منهم ومفادها أن كل جملة تُقال أو تُكتب ينبغي أن يتبعها بسرعة سيل من الاستثناءات والاحترازات كي لا تُفهم خطئا أو على غير مراد المتكلم
حسنا... الورع شيء جميل بلا شك ومحاولة الضبط لا بأس بها لكن الخلل هو تحول ذلك إلى نوع من الوسوسة وإلزام المتكلم ما لا يلزمه الشرع ولم تقتضه اللغة
لتوضيح ما أقصد إليك هذا النقل الجامع من كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.. يقول ما نصه: "من فصيح الكلام وجيده الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص والتقييد، وعلى هذه الطريقة الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وكلام العلماء، بل وكل كلام فصيح، بل وجميع كلام الأمم، فإن التعرض عند كل مسألة لقيودها وشروطها = تعجرف وتكلف وخروج عن سنن البيان وإضاعة للمقصود وهو يعكر على مقصود البيان بالعكس، وقد لا يستحضر المتكلم جميع الشروط والموانع فإن هذا في كثير من المواضع لا يكاد ينضبط. بل من فصيح الكلام أن من تكلم في شيء كجهة من الجهات لم يلتفت إلى غير تلك الجهة"
هذا هو ببساطة ما يقتضيه الفهم الطبيعي والعقل المستقيم ويجيب بوضوح عن هذا التساؤل: هل يُشترط عند أي قول بيان كل احترازاته واستثناءاته؟
الإجابة لا
نموذج ضرب الزوجة
وهذا واضح من مثال سعد بن عبادة الذي صدرت به كلامي، وأعظم منه ما في كتاب ربنا وله أمثال كثيرة أذكر منها واحدا فقط.. قول ربي ﷻ "وَٱلَّـٰتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِی ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ"
لفظ الضرب يحتمل كل أنواعه؛ الضرب بالعصا أو بالسوط أو حتى بالسيف، فهل يفهم ذلك المعنى أحد رغم عدم وجود الاحتراز أو الاستثناء في الآية؟
قطعا لا؛ الكل إلا أهل الشبهات يحملون الآية على الضرب غير المبرح
إذًا فما وقع فيه المتأخرون من ضرورة تكلف الاحتراز في كل كلمة؛ لا ينبغي اشتراطه خصوصا في الحالات الواضحة الجلية التي اقترنت بدلائل المقصود
وذلك ما نفعاه في حياتنا يوميا
هل إذا طلبت منك كوب ماء في يوم قائظ شديد الحرارة أنا مضطر لأن أشترط ألا يكون الماء مغليا أو متسخا؛ أم فقط يمكنني أن قول أعطني كوب ماء ويفترض أن مقصدي عندئذ سيكون واضحا؟
إذًا فلا يوجد داعٍ مستمر إلى أن يقال كل شيء في نفس اللحظة أو في نفس السياق أو في نفس الموقف؛ لستَ مضطرا كلما تكلمت للتترس والدفاع عن نفسك بدروع الاحترازات والتقييدات.
نماذج أخرى
مثلا إذا أردت أن تنتقد فئة ما فهل لا بد أن تقدم بين يدي نقدك لهم كلمة (بعض) لأن اللفظ العام يخصصه مقصدك وكلامك الآخر وعرف الناس اللغوي
نقدك في سياق الحديث عن النساء مثلا يعني ببساطة أنك تقصد السيء منهن ولا يعني أنك تقصد أن كل النسوة سيئات، كذلك عند حديثك عن مهنة معينة أو بلدة أو حي... إلخ
في المقابل عند ثنائك على لغة شخص أو بيانه أو أحد أعماله أو حتى رثائك له إن قضى نحبه = هل لا بد أن تقدم ذلك بقولك "رغم اختلافي مع فلان" أو "بالطبع أنا أختلف معه في أشياء" أو أن تختمه بقولك "ولا تعجبني في فلان أمور وتصرفات"؟
الحق أنك لست مضطرا لكل هذا التكلف إلا في بيئات يسودها الظن السيء والفهم السقيم، ذلك لأنك يقينا ستختلف مع غيرك في نقاط ويصعب جدا أن تتفق مع غير معصوم على طول الخط ويفترض أن كل ابن آدم خطاء وأنك بلا شك لن تحب الخطأ
كل هذا واضح ومطلق أليس كذلك؟
فما قيمة تكراره كل لحظة وتأكيده بشكل محموم وكأنك تنفي عن نفسك تهمة؟! بل إن ذلك كثيرا ما يؤدي إلى إحداث أثر عكسي ويعد في نظري قلة ذوق.. أثنيت على شخص أو فئة ثم أردفت: "رغم أخطائهم" أَو قلت: "وفيهم خطأ وصواب"، ثم لم تبين تلك الأخطاء أو تناقشها بل تركتني فريسة الظنون وتوقع تلك الأخطاء الجسيمة التي رفضت ذكرها تورعا.. ليتك لم تثن عليه ولا رثيته ابتداءً.
إن قصد المتحدث معتبر في التخصيص ولا داعي لكثرة الاحترازات الفورية، الأصل أن الحديث يتضح بحسب السياق المظهر لقصد القائل وما عُرف عنه. تخيل مثلا أن يمدح أحدهم الشتاء، ثم يأتي محب للصيف فيقول ولماذا لم تذكر مساوئ الشتاء حين يشتد المطر وتزأر العواصف وتتحول الشوارع إلى برك من الماء والطين؟ لأنه ببساطة مفهوم.. هو أكيد لا يحب التمرغ في الطين ولا يعشق ارتجافات البرد ولا يهوى أمراض الشتاء، لماذا عليه أن يتكلم بما هو واضح؟
تخيل أن تكتب ناصحا الأزواج بأمور قد تحسن حياتهم الزوجية فيسارع مدمنو الاحترازات باتهامك بالانحياز للنساء أو للرجال وأن كلامك انتقائي ناقص لأنك لم تذكر الطرف الآخر في السياق نفسه
تخيل أن تتحدث عن فضيلة حث عليها الشرع كصلوات النوافل فتطالب مباشرة بالاستدراك محذرا من تأثير ذلك على الفرائض وأنها أهم طبعا، الحقيقية أن باب الاحترازات والاستدراكات لو فتح فلن يقف على ذلك ولكن سيصل إلى أن تصمت تماما لأنك ببساطة لن تستطيع الإحاطة بكل احتراز.
لنضرب مثالا بذلك التخيل الأخير.. صلاة النافلة
ليس الاحتراز فقط ألا تؤثر في فريضة، ماذا عن ماء الوضوء ألا ينبغي أن أحذرك من الوضوء بماء مغصوب أو الصلاة على أرض مغصوبة إن كنت من القائلين بذلك؟ ألا ينبغي أن أدعوك للاحتراز من التقصير في حق أهلك ومن تعول بسبب إكثارك من النوافل؟ ألا ينبغي أن أبين لك ضرورة الإتيان بأركان الصلاة حتى لو كانت نافلة وأفصل لك في شروطها وفوارقها عن الفريضة؟
صدقني يا عزيزي إن الاحترازات لا تنتهي .. ولن تنتهي
جمع الاحترازات
ولو أن إنسانا اشترط إحصاء الاحترازات في كل كلمة يقولها = لما نطق أبدا
في الشرع نفسه - كتابا وسنة - ستجد متشابهات ومجملات يتم إرجاعها إلى المحكم أو ردها إلى المفصل كي يتم الفهم
نعم... إن خطاب الشرع لم يكن الغالب عليه أبدا ذلك الاحتراز الدائم؛ بل كان جمع النصوص في المسألة هو ديدن أهل العلم ذلك لأن صاحب الشرع لم يذكر في نص واحد كل شرط وضابط واحتراز
وكثيرا ما كان النبي ﷺ يجمل قواعد عامة تُفهم استثناءاتها من آيات وأحاديث أخرى
مثلا قوله "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" هكذا فقط؟! هذا هو الحديث.. وذلك هو تمام السياق
وأحاديث أخرى كتير فيها الفكرة نفسها أو ما يشبهها باختلاف الروايات؛ مرة باشتراط الصدق وأخرى باليقين وثالثة بالإخلاص، المهم أن الحديث الواحد يطلق ويعمم
دخل الجنة.. هل معنى هذا أن يفعل ما بدا له؟ هل يفهم من هذا أن يكتفي بالقول دون الأعمال المترتبة على القول؟ هل يتصور أن يقصد النبي حين قالها مطلقة ألا شروط ولا نواقض ولا استثناءات
قطعا لا؛ لأن هناك نصوصا أخرى وأدلة مختلفة، وهذه الأدلة جاءت في أكثر من سياق.. لكن ببساطة لم يكن هناك اضطرار في كل مرة يذكر فيها الإيمان أن تذكر شروطه ونواقضه وأركانه وتفصيلاته
وهكذا سائر الكلام
لا يشترط أن تكون رافضا أو نافيا لكل شيء لم تذكره في كلامك ببساطة لم يتسع المقام لتفصيله
ولا يشترط أن يسيطر عليك إحساس دائم بالخوف من سوء فهم الكلام أو حمله على غير محمله الصحيح أو مرادنا منه مما يؤدي إلى تكلف تقرير المتقرر وتوضيح الواضح وربما تكرار ذكر السيرة الذاتية c.v للمرء في كل مرة كي لا يساء فهمه
قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا تعني أن يصير كل الوقت = وقت حاجة؛ الأمر الذي يشكل عنتا رهيبا يستحيل معه إحصاء كل الأمور كلما أراد المرء أن يتكلم
لماذا إذا نصر على تكلف ما لم نُكَلَّف ونحمل أنفسنا وغيرنا ما لم يحملنا به ربنا الرؤوف الرحيم؟
لماذا؟!