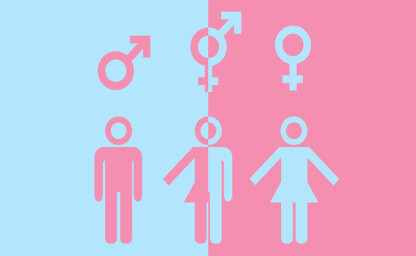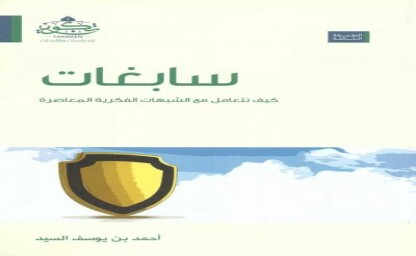«إن الفرد لا يولد امرأة، وإنما يصبح امرأة». مثّل هذا التقرير للفيلسوفة الفرنسية الشهيرة سيمون دي بوفوار شعارًا مهما في مسيرة الموجة الثانية من الحركة النسوية؛ فهو كان التدشين الأول للفكرة التي ستصبح خطة العمل الرئيسة للبحث الأكاديمي النسوي، وكما تؤكد ويندي سيالي هاريسون، فإن: «التفريق بين الجنس/الجندر كان أساسيًا للازدهار الكامل للموجة الثانية من النسوية... وقد تبع ذلك ما يزيد على الثلاثين سنة من البحث النسويّ المثمر بشكل هائل، والذي أثبت أن ما كشفه مصطلح «الجندر» كان مجالا واسقا وخصبًا فكريًا».
تدور الفكرة الرئيسية لمفهوم الجندر حول أن «صفاتنا النفسية والاجتماعية وأدوارنا لا تولد معنا بل نكتسبها من خلال التربية والثقافة المحيطة» وأن «الاختلاف الطبيعي الوحيد بين الذكر والأنثى هو في تلك الوظيفة [الإنجاب]. أما الاختلافات الأخرى من حيث الطباع أو الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها كل من الذكر والأنثى، فهي ليست مرتبطة بالاختلافات البيولوجية أو الفيزيولوجية الموجودة في جسد كل منهما، بل بسبب عوامل اجتماعية صنعها البشر أنفسهم».
فصل الأدوار الاجتماعية
فمفهوم الجندر في أساسه النظري عملية فصل بين الأدوار الاجتماعية والطبيعة البيولوجية، أي «أن دي بوفوار تفصل ما بين الجنس كبيولوجيا وبين الجنوسة [الجندر] باعتبارها تشكلا اجتماعيا ثقافيا». ثم هو ينظر لهذه الأدوار الاجتماعية باعتبارها وسائل يستعملها النظام الذكوري لترسيخ هيمنة الرجال على النساء عبر ربط معنى الأنوثة بالأمومة والحياء والرقة مثلًا وجعلها نتيجة لذلك خاضعة لسلطة المجتمع والأسرة. بينما في الحقيقة -بالنسبة للمتبنين لمفهوم الجندر- لا توجد علاقة بين هذه الصفات النفسية والاجتماعية وجنس الأنوثة.
ومفهوم الجندر بهذا التوصيف هو نظرية اجتماعية. فهو «يشكل عند مستخدميه معيار التفسير لفك شفرة الحياة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية، من خلال فكرة رئيسة: الاختلافات بين النساء والرجال ليست مرتبطة بتغاير طبيعي. ولكنها نتاج بنية ثقافية. والتي نظقت برمتها لترسيخ الهيمنة على جنس من طرف الآخر.. فمفهوم النوع [الاجتماعي أو الجندر] يغطي كذلك رؤية معينة إلى العالم ونظرية. المفهوم نفسه لا ينفصل عن الفرضية التي يرتكز عليها، التي تذعي السمة الثقافية والتي تنبني على الاختلاف بين الرجل والمرأة».
وبما أنه يمثل مفهوما ضمن نظرية اجتماعية فهو بصورة حتمية متحيز وذو اتصال مع أرضية ثقافية وفلسفية ينطلق منها ويفترضها. وفي ذلك يقول الدكتور خالد بن عبد العزيز السيف: «إن أي مصطلح لا يمكن أن يُولد في فراغ. ولذلك فهو ينتمي إلى المنظومة الفكرية والفلسفية التي ولد فيها ومرجعيته هو الحقل والسياق الثقافي والمعرفي الذي عبر عنه إبان تشكله، ويمكن أن يعبر عن السياق الذي تشكل فيه بأنه هو هوية المصطلح. ولذلك فكل بحث في دلالة المصطلح دون اعتبار لهوية المصطلح يعتبر بحثا غير مكتمل الجوانب، فكثير من المصطلحات ليست مفاهيم عالمية كونية متعالية عن الزمان والمكان، وليست متجردة عن الخصوصية التاريخية والحضارية، بل تتحيز هذه المصطلحات إلى هويات راسخة سواء كانت فلسفية أو دينية..»
لكن وكما تذكر الأستاذة ملاك الجهني: «استخدام المفاهيم التحليلية الغربية بطريقة انتقائية بحيث ننتقي منها ما يناسبنا من الدلالات وننفي أخرى لا يفصم المفهوم عن جذوره ولا يفرغه من حمولته الثقافية بحال». لذلك التعامل مع المضامين التي يقدمها مشروع الجندر كحقائق نهائية يتجاهل حقيقة كونها مجرد نظرية اجتماعية. وكما يذكر فرانسوا-كزافييه بيلامي: «المدافعون عن هذا المفهوم الذين يستخدمونه بشكل واسع اليوم ... يرفضون بشدة أن تكون «نظرية» ما مخفية وراء هذا المفهوم. ولكن هذا الرفض ليس له ببساطة أي معنى.. تفسير التاريخ والأدب والحياة الاجتماعية كأماكن للهيمنة الذكورية من خلال إقامة القوالب النمطية حول الجنسين. يمكن أن يكون فرضية للاشتغال؛ ولكن الأمر يتعلق كثيرا بنظرية خاصة. وبهذا الصدد فهي لا تملك دليلا مؤكدًا لا جدال فيه.»
الجندر والموقف الأخلاقي
ومن الجوانب المهم الوعي بها أيضًا -إضافة إلى أن مفهوم الجندر ينطلق من أرضية فلسفية ونظرية اجتماعية محددة- فإن مفهوم الجندر أيضًا لا ينفصل عند أكثر المتبنين له عن الموقف الأخلاقي المصاحب له، فقد تم الربط بين عملية وضع الأدوار الاجتماعية للرجال والنساء بفكرة هيمنة الرجال على النساء. باعتبار أن الحديث عن وجود تغاير «طبيعي» بين الرجل والمرأة هو ادعاء تم استعماله لمدة طويلة لقمعها والهيمنة عليها وجعل ذلك أمرا طبيعيا وبذلك سيستعمل الجندر لتفكيك هذه «الطبيعية» ولبيان أنها اجتماعية؛ أو على حد وصف كاملا بهاسين: «طرح الاختلاف بين «الجنس» والنوع الاجتماعي «الجندر» لمعالجة التوجهات العامة التي ترجع خضوع المرأة إلى تركيبتها الجسدية. إذ ساد طويلًا الاعتقاد بأن التباين بين خصائص دور المرأة والرجل ومكانة كل منهما في المجتمع تحدد وفقًا للتصنيف البيولوجي للجنس المعين، لذلك اعثتبرت هذه الخصائص طبيعية وغير قابلة للتغيير. بهذا المفهوم: ظل التكوين الجسدي للمرأة، ولا يزال، سببا مباشرا لخضوعها في المجتمع. وفي حالة قبول هذا كوضع طبيعي من البديهي ألا تثار قضية عدم المساواة وعدم العدل في المجتمع». ولذلك يتم النظر إلى الاختلافات في بعض التشريعات الاجتماعية بين الرجال والنساء وردّها إلى اعتبارات تتعلق باختلاف طبائع الرجال والنساء على أنها وسيلة للحفاظ على الهيمنة الذكورية من الرجال على النساء.
المصدر:
مجلة أوج