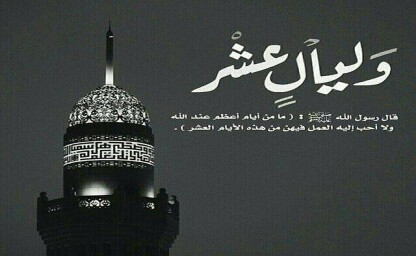يقوم المذهب الربوبي على عدد من الأصول التي باجتماعها تتجلى الرؤية الكونية الكبرى لأنصاره، وأهمها:
- الإله واحد ليس له شريك، وهو ذات مفارقة للطبيعة، فاعلة ومريدة.
- الكون محدد، ويعمل ضمن ناموس ميكانيكي داخلي مستغن عن العناية الإلهية للبقاء والسيرورة.
- الكون هو المظهر الوحيد لمعرفة الله، فهو كتابه المقدّس. ومعرفة الإنسان إلهه -بذلك- أشبه بمعرفتنا بالرسّام وذوقه بعد النظر في اللوحة.
- العقل هو المصدر الوحيد لمعرفة الله، ومبدأ الوجود والغاية منه، والأخلاق التي يرضاها الخالق.
- المعجزات لا تحدث؛ لأن الإله غير قادر على إحداثها إذ إن قوانين الكون لا تتغير أو لأنه لا يريد ذلك.
- يؤمن جل الربوبيين بحياة بعد الموت للجزاء، إثابة أو عقابا.
الخلل الأكبر في اللاهوت الربوبي كامن في زعمه أن الله -سبحانه- قد خلق، فأتقن ما بدع -وإن أنكر بعضهم عليه أمور الألم في الكون- ثم أدبر عن هذا الوجود وأهمله، منشغلا بحديث أمره عمّا يجده لخلقه. وهو تصور طفولي للإله، ومن مظاهر طفوليّته مشابهته أو قل مطابقته للتصورات الوثنية للآلهة القديمة في مصر وبابل واليونان. فهذا التصور ليس ببعيد عن صورة الإنسان إذ يصنع كرسيًا أو مشبك ملابس، فيتقن صورته، ثم هو يواريه أحد الأدراج أو يضعه في المخزن ليلفّه النسيان بلحاف الإهمال.. هو تصور بليد، ميت، بلا روح؛ إذ يعدم كل ما اهتدى إليه العقل من معرفة شائقة بكمال قدرة الربوبية.
إن الألوهي الذي يتشوف إلى رسالة السماء من بوابة النبوة هو وحده الذي يسير على سكة سهلة غير متعرجة ولا متدحرجة إلى أسفل؛ إذ يترقى من العلم بوجود الرب إلى طلب العلم بحقيقته ومراداته؛ فالقاعدة عنده أن الحكمة الكاملة لا تنتحر، وإنما هي حبلى بالمعنى والأمل، وكمال الصفات عنده وجه لكمال الذات.
والربوبي الذي يرى قداسة العقل، وأنه مصدر العلم بالرب والخلق والمآل، أسير سكرة الإعجاب بما فتح له من زوايا المعرفة؛ إذ العقل لا يملك من آفاق المعرفة بالرب غير بعضها؛ كالخلق، والقدرة، ثم تنيخ ركائبه؛ ولذلك فالتصور الربوبي يقضي عليه بالأسر في قفص الجهل بالخالق، كما يقضى على الخالق أن يتسربل بصفة الشحّ على الخلق بالمعرفة، ويرميه بنقيصة الاستمتاع بحيرة الإنسان وتيهه
والربوبي -في حقيقة الأمر- شر حالا من الملحد؛ إذ الملحد لا يرى في الوجود غير ركام من الأشياء بلا غاية، وآكام من النظم مبعثرة؛ فيبني على ذلك أن الكون عبث بلا هدف، بلا حكمة، وأما الربوبي فيرى الحكمة في خلق الذرة والمجرة، ويدرك مظاهر العظمة فيها، ثم هو ينتكس بعد ذلك إلى مذهب الملحد نفسه؛ فلا يرى في الوجود غير أشياء تسير إلى حتفها رغم أنفها.
والربوبية -على الصواب- مظهر من مظاهر الكسل المعرفي؛ ﻷنها وقوف على تخوم الإيمان والإلحاد؛ فلا الباحث أكمل المسير إلى نهاية الغاية من الخلق، ولا هو أدبر إلى نقطة الإنكار لقيمة الأشياء المتراكمة في حيّز الوجود.
وهي -الربوبية- في تاريخها الحديث، أثر عن الكفر بالنصرانية وعقائدها ومؤسساتها الدينية المفسدة في الأرض. فقد أدى الكفر بالنصرانية في عصر الأنوار في أوروبا إلى الكفر بكل دين؛ ﻷن فساد النصرانية يلزم منه فساد كل الأديان، فلن تكون أديان الشرق، وخاصة دين الترك (اسم الإسلام في تلك الفترة) أفضل حالا من النصرانية.. وهذا احتكام من فلاسفة الأنوار إلى الجهل، وفرغ عن آفة التعالي الذي هيمن على العقل الغربي بظنه أن الشرق أدنى من الغرب في كل شيء.
أنا لا أصدق أن نفسًا ترى هذا الكون وعظيم صنعه، والعطايا ولذيذ طعمها، والجمال ودقيق ملحمة؛ ثم تكتفي بالإيمان "بمهندس عظيم" وراء ذلك، خلق وصوّر، ثم أدبر.. سيظل الإبهار والإمتاع في الكون مصدر قلق للربوبي الصاحي يجذبه إلى مصدر النور الخفيّ، ويستحث عقله المتقلب نظره في الآفاق البعيدة ليستعجل فك شفرة المبدأ والغاية.
المصدر:
د. سامي عامري، براهين النبوة، ص31