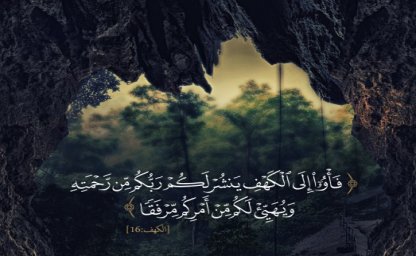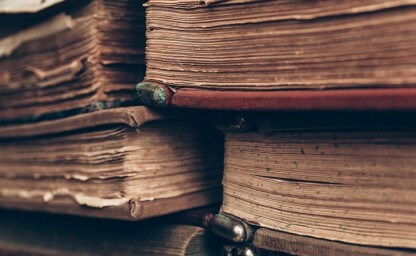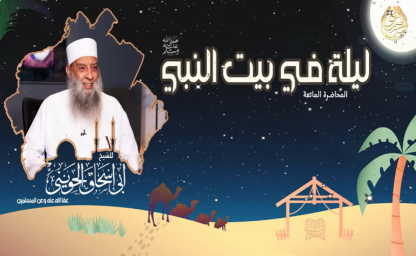بمناسبة يوم اللغة العربية والكلام عن قيمتها.. يحضرني عبقرية الفقهاء قديمًا في اختيار مصطلحاتهم في الفقه وفي العلوم.. كيف ربطوا من خلالها بين العلم والدين ببراعة شديدة؟! وكيف وسِعت العربية الفذة هذا الأمر؟!
تأمل مثلًا استعمالهم لفظ "المُكلف" للتعبير عن المخاطب في الكلام.. فأي فعل لا ينفك عنه معنى الافتقار والعبودية.. يمكن أن تفهم ذلك أكثر من ملاحظة استعمال القانون مثلًا للفظ "العاقل" للتعبير عن المخاطب..
فالعقل عند الفقهاء يدور دومًا في فلك النص.. لذلك نجدهم حين يتكلمون عن التكاليف الشرعية يفيضون في الكلام عن دورها في إشباع الحاجات النفسية للإنسان أكثر من كلامهم عن عقلانيتها، وهذا الإشباع يرتد كله في النهاية لفكرة أساسية هي العبودية..
والعبودية في لفظ "التكليف" تحمل معنى التشريف.. ذلك أن المعرفة في الشريعة مكونة من ثلاثة أجزاء: معرفة الفعل، ومعرفة درجة الالتزام بالفعل، ومعرفة الآمر بالفعل.. لذلك كان التكليف دومًا جديرًا بالثناء والمدح، لأن مصدره الله عز وجل..
وانظر كيف عجزت الإنجليزية عن فهم هذا الأمر.. فتجد الغربيين حين ترجموا لفظ "التكليف" وفهموه؛ استعملوا في التعبير عنه لفظ "العبء"، والفرق بينهما كبير جدًا، فرغم أن كليهما يتضمن التزامًا وينطوي على المسئولية، إلا أن التكليف نوع من التشريف، إذ يُشير إلى مجموعة من العلاقات الخاصة بين المُكلِّف / الخالق، والمُكلَّف / المخلوق أهمها: الاستخلاف والعبودية..
تخيل كل هذا في لفظ واحد هو "التكليف".. وكنت قد كتبت في منشور سابق عن مثال آخر هو لفظ "الحياء" وكيف فهمه الغربيون بمعنى "الخجل".. والفرق بينهما كبير..
يمكن أن نذكر نحو ذلك في "المروءة" وعشرات القيم التي لا يوجد نظير لها في الغرب ولا تعرفها الإنجليزية!
المفاهيم الشرعية تتضمن في ذاتها مضامين مدح ومضامين ذم.. وهي بدورها تحمل انعكاسات في نفوس المخاطبين بأحكامها، تحملهم على تهوينها أو تعظيمها!