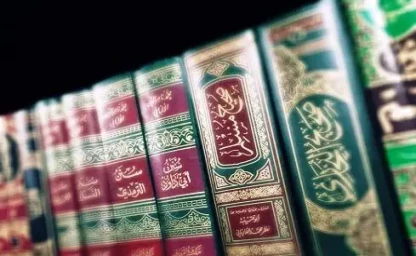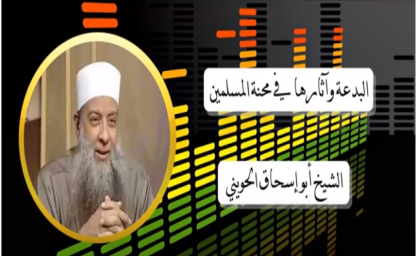لا خلاف بين العلماء أنَّ المحافظة على ألفاظ الحديث وحروفه أمر من أمور الشريعة عزيز، وحُكْمٌ من أحكامها شريف، وأنه الأولى بكل ناقل والأجدر بكل راوٍ المحافظة على اللفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، بل قد أوجبه قومٌ ومنعوا نقل الحديث بالمعنى.
والذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازوها بشروط وتَحَوُّطَاتٍ بالغة فقالوا: نَقْلُ الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، أما العالم بالألفاظ الخبير بمعانيها، العارف بالفرق بين المُحْتَمَلِ وغير المُحْتَمَلِ، والظاهر والأظهر، والعام والأعمّ، فقد جَوَّزُوا له ذلك، وإلى هذا ذهب جماهير الفُقَهَاء والمُحَدِّثِينَ.
وقد كان السلف الصالح يحرصون على الرواية باللفظ ويرون أنَّ الرواية بالمعنى رُخْْصَةً تتقدَّر بقدرها، وكان منهم مَنْ يتقيد باللفظ ويَتَحَرَّجُونَ مِنَ الرواية بالمعنى، قال وكيع: «كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حَيْوَةَ - رَحِمَهُمْ اللهُ - يعيدون الحديث على حروفه» ومِمَّنْ كان يُشَدِّدُ في الألفاظ الإمام مالك - رَحِمَهُ اللهُ - فقد منع الرواية بالمعنى في الأحاديث المرفوعة وأجازها فيما سواها، رواه البيهقي عنه في "المدخل".
ومن السلف من كان يرى جواز الرواية بالمعنى، قال ابن سيرين: «كان إبراهيم النخعي والحسن والشَعْبِي - رَحِمَهُمْ اللهُ - يأتون بالحديث على المعاني» (1).
ومِمَّا ينبغي أنْ يُعْلَمَ أنَّ جواز الرواية بالمعنى في غير ما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أنْ يُغَيِّرَ لفظ شيء من كتاب مُصنَّف ويُثْبِتَ بَدَلَهُ فيه لفظًا آخر بمعناه، فإنَّ الرواية بالمعنى رَخَّصَ فيها مَنْ رَخَّصَ لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأنه إنْ ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره كما قال ابن الصلاح (2)
ومِمَّا ينبغي أنْ يُعْلَمَ أيضا أنهم استثنوا من الأحاديث التي جَوَّزُوا روايتها بالمعنى الأحاديث التي يُتَعَبَّدُ بلفظها كأحاديث الأذكار والأدعية والتشهد ونحوها كجوامع كلمه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرائعة.
فإذا علمنا أنَّ التدوين الخاص وجد في القرن الأول، وأنَّ التدوين العام كان في أول القرن الثاني، وأنَّ الرواية بالمعنى لا تجوز في الكتب المدونة، والصحف المكتوبة، وأنَّ الذين نقلوا الأحاديث وَرَوَوْهَا منهم من التزم اللفظ ومنهم من أجاز الرواية بالمعنى، وهؤلاء المُجِيزُونَ كانوا عربًا خلصًا غالبًا، وأنهم كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وأنهم قد سمعوا من الرسول أو مِمَّنْ سمعوا من الرسول وشاهدوا أحواله، وأنهم أعلم الناس بمواقع الخِطاب ومحامل الكلام، وأنهم يعلمون حق العلم أنهم يَرْوُونَ ما هو دين، ويعلمون حَقَّ العلم حرمة الكذب على رسول الله، وأنه كذب على الله فيما شرع وحكم.
إذا علمنا كل ذلك - وقد دَلَّلْنَا فيما سبق - أَيْقَنَّا أنَّ الرواية بالمعنى لم تَجْنِ على الدِّينِ، وأنها لم تُدْخِلْ على النصوص التحريف والتبديل كما زعم بعض المُسْتَشْرِقِينَ وَمَنْ لَفَّ لَفَّهُمْ، وأنَّ الله الذي تَكَفَّلَ بحفظ كتابه قد تَكَفَّلَ بحفظ سُنَّة نبيِّه من التحريف والتبديل، وقَيَّضَ لها في كل عصر من ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المُبطلين، وتأويل الجاهلين، فذهب الباطل الدخيل، وبقي الحق مورَدًّا صافيًا للشاربين {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} (3).
المصدر:
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين، محمد أبو شهبة
الإشارات المرجعية:
- جامع الأصول ج ١ ص ٥٤، الباعث الحثيث ص ١٦٦.
- مقدمة ابن الصلاح ص ١٨٩.
- [سورة سبأ، الآية: ٤٩]