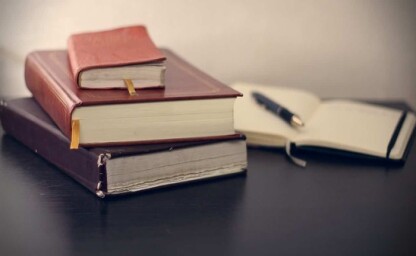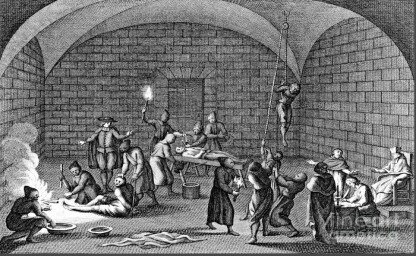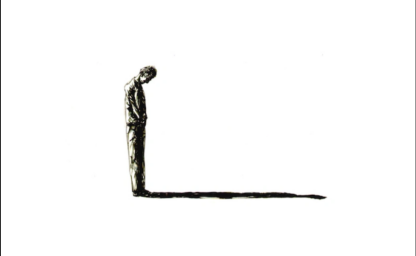أصل الشبهة:
هم يسمحون لنا ببناء المساجد فلماذا لا نسمح لهم ببناء الكنائس؟ وهم يسمحون للمسلمين بالدعوة إلى الإسلام فلماذا لا يُسمح لهم بمثل ذلك؟ وهم يهنئوننا بأعيادنا الدينية فلماذا لا نقابلهم بالمثل؟ ومقولات أخرى تُكرر ذات المعنى: كما أن غير المسلمين يفعلون معنا شيئًا معينًا، فلماذا لا نقابلهم بالمثل فنفعل لهم الشيء نفسه؟!
صاحب هذه المقولة يستند إلى ما يتوهمه مندرجًا تحت قاعدة العدل المعروفة، فإذا أحسن إليك شخصٌ ما فعليك أن تقابل إحسانه بإحسان، بل قد يظن بعض الناس أن مقتضى الفضل الأخلاقي هنا أن تتجاوز هذا فتعامل الناس كما تحب أن تُعامَل.
وبعيدًا عن مناقشة بعض القراءات الرومانسية الحالمة للواقع، والتي تصبغ المجتمعات الغربية بألوان من التسامح تتجاوز حقائق الواقع، وتتغافل عن كثير من التعقيدات النظامية الإجرائية الموجودة عندهم، وأنهم كثيرًا ما يفرقون في تعاملهم بين ما كان من أعرافهم وتقاليدهم وأديانهم وما كان وافدًا عليهم منها، وقد يتجاوزون ذلك إلى مصادرة عدد من الحقوق كأن يفرضوا على المسلمين ما يخالف دينهم، أو يمنعونهم مما يجب عليهم كمنع النقاب، أو بناء المساجد، أو إعلاء المآذن أو غير ذلك.
فالإشكال مع هذه المقولة أنها تنسى في غمرة الخضوع لأوهام المساواة والعدل مسلَّمة بدهية، وهي أن كل شخص له مرجعية عُليا يحتكم إليها في معرفة الصواب والخطأ، وتحديد الحق والباطل، فلا يصح أن يخضع لضغط الحالة النفسية والهوى الخاص في مقابلة الشيء بمثله فيقع في مخالفة هذه المرجعية وتعطيلها.
الأصول القطعية
فمع الإقرار بحسن مقابلة إحسان الآخرين بمثله، بل وأن يتجاوز المرء ذلك إلى الفضل والإحسان، لكن حين تكون هذه المقابلة ناقضة لأصل قطعي، أو مخالفة لأمرٍ أو نهي شرعي فإن الوضع يجب أن يختلف تمامًا، فلا يصح شرعًا ولا عقلًا أن نفكر بخيار المقابلة بغض النظر عن طبيعة هذه المقابلة، بل يجب أن تكون المقابلة غير مخالفة للشريعة.
وفي الأمثلة السابقة في أول الكلام نجد أنها تتضمن دعوة إلى مخالفة أحكامٍ وأصولٍ شرعية واضحة لمجرد تحقيق المقابلة، فبدلًا من أن نخضع مثال المقابلة إلى أصول شرعنا، أصبح شرعنا محكومًا بهذه المقابلة، فالحكم عندنا يكون حرامًا ومنهيًا عنه لما فيه من ضرر وفساد، لكن إذا فعلوا لنا شيئًا مثله فيجمل بنا أن نتخلى عن أحكامنا، ونجعله مباحًا من باب المقابلة!
إن المسلم يتبع حُكم الشريعة في أوامرها ونواهيها، فإذا كانت المقابلة مما لا تمنع منه الشريعة فلا إشكال هنا في المقابلة بالمثل، وقد جاءت الشريعة بتقرير هذا الأصل، وأمرت بمقابلة الإحسان بإحسان: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، بل جاءت الشريعة بما هو أشرف وأجمل من بذل البر والإحسان، وهو قدر زائد على محض العدل (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).
منظومة التشريعات الإسلامية
والأمر يقوم على بدهية شرعية تتصل بمنطق الحق والباطل في التصور الإسلامي وما يترتب على كل واحد منهما من أحكام وآثار، فالإسلام جاء بمنظومة من التشريعات العقدية والعملية انطلاقًا من حقيقة كونه حقًا وما سواه باطل، ولذا صح فيه أن يكون فرقانًا بين الحق والباطل، لا على مستوى التصور النظري أو الحكم الأخروي فحسب، بل وعلى المستوى العملي وفق منظومة تشريعية يميز من خلالها بين قيم الحق وقيم الباطل، وينتفي المساواة فيه المساواة بينهما، فالحق متمايز عن الباطل، والتسوية بينهما ظلم: (فماذا بعد الحق إلا الضلال).
وتميز الشريعة بين حَمَلَةِ الحق وحَمَلَةِ الباطل، فالطائفتان لا يستويان: (وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ * وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ)، (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)، (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)، (لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ).
والأمثلة والشواهد على الممايزة بين الحق والباطل وأصحابهما في تفاصيل التشريعات العملية أكثر من أن تُذكر في أبواب العبادات والجنايات والحدود والمواريث والأنكحة والأطعمة والشهادة والولاية والحضانة وحرية التعبد، وغيرها.
شواهد
وخذ هذه الشواهد مختصرة للتدليل على سعة الشبكة التشريعية التي تؤكد بدهية نفي المساواة بين حق الحق وحق الباطل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا)، (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)، (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)، (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)، (لا يقتل مسلم بكافر)، (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)، (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)، (لا يترك بجزيرة العرب دينان)، (من تشبه بقوم فهو منهم).
هذه بعض الشواهد المختصرة، وهي كافية في التأكيد على هذه الحقيقة الشرعية المحكمة، وهي تغني عن الاستطراد والاستغراق في ذكر الفروع الفقهية الناشئة عن هذه الشواهد في مختلف الأبواب الشرعية، وهي كلها تصب في التأكيد على قاعدة من قواعد الشريعة تتابع العلماء على ذكرها، ولفظها مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه). وذلك أن الإسلام حق، وما سواه باطل، والباطل لا يعلو على الحق بحال.
إشكالية المقابلة بالمثل
وفي ضوء هذا فلا يصح أن تُضفى شرعية على الباطل بذريعة المقابلة بالمثل، فلا يلزم من إعطاء حقِّ الدعوة للشريعةِ الحقّ، أن يُعطى الباطل المصادم للشريعة ذات الحق، فالمسلم ينطلق في تصوراته من كون الإسلام حقًا، ويتعامل مع الأفكار المخالفة له على أساس أنها باطل ليس لها ذات الشرعية، وبناء عليه فلا ينبغي أن يجد في نفسه أي تناقض إطلاقًا حين يفسح المجال للحق ليعمل في الواقع ويجهد في منع جيوب الباطل أن تتمدد.
إن هذه الرؤية الشرعية المحكمة تعارض من يريد تقرير لزوم المقابلة بالمثل، فهو لا يستحضر وجود رؤية فكرية حاسمة تجعل من نفسها منفردة بوصف الحق في مقابل الحكم ببطلان الرؤى المضادة لها، بل كثير من هؤلاء يتبنى القول بنسبية الحقيقة وعدم إمكان امتلاكها، وهو ما يمكن أن يفسر مشكلة تبني مثل هذه المقولة، إذ هو متأثر بتبني رؤية سائلة في محاكمة الحق والباطل، ليس لديها وضوح في الحدود الفاصلة بينهما، بما سيفرز المطالبة بمساواة الحق بالباطل.
ربما يقول بعضهم معترضًا: لكننا لا نرى أن هذه الأمور محرمة شرعًا؟
وهذا تصحيح للمقولة وعودة بها إلى محل البحث الحقيقي: هل هذا الأمر المعين المخصوص مما تقبل الشريعة المقابلة بمثله أم لا؟ فهذا انتقال صحيح لمحل بحثٍ مشروع، وهو يوجب النظر في هذه القضايا والسعي لإدراك حكم الشريعة فيها، فإن كانت مقبولة شرعًا قُبلت وإلا ردت، ويجب أن يكون المسلم واعيًا لئلا يخضع لمثل هذه المقولة التي تأتي حاكمة على الشريعة من حيث لا يشعر.
إذن، الجواب عن أي سؤال يقول: هم يفعلون لنا، فلماذا لا نفعل لهم كما يفعلون؟ أن نقول: أن لنا مرجعية نحتكم إليها، وعنها نصدر فيما نأتي ونذر، ومن خلالها ننطلق في بناء تصوراتنا ومفاهيمنا، وأما الآخرين فلهم تصوراتهم ومفاهيمهم المنسجمة مع مرجعياتهم.
خطورة هذه الشبهة
ومن خطورة هذه المقولات أنها تتسبب أحيانًا فيما يمكن أن نسميه بـ(تبديل المرجعية) فيتحول الشخص من مرجعية إلى مرجعية أخرى وهو لا يشعر.
فحين نأتي إلى هذا السؤال المشهور:
لماذا لا نعطي الكفار من الحرية في التدين، واللباس، وبناء المعابد كما هو متاح من حريات في النظام العلماني الغربي، ولماذا تنكرون عليهم أي انتهاكٍ لحقوق المسلمين، في مقابل أنكم لا تضمنون لهم مثل هذه الحقوق، ولا ترون أن في منعهم منها أي انتهاك، بل قد تباركونه؟
يتورط بعض الناس في الجواب عن هذا الإلزام فيضطر أن يَطَّرِدَ في الجواب فيقول: بل الحريات مكفولة لهم في نظامنا الإسلامي بذات الطريقة التي يحفظون بها حريات المسلمين، فلهم حرية اللباس والتعبد والدعوة كما لنا من حرية في بلادهم.
الذي حصل هنا أن مقولة (نسمح كما يسمحون لنا) تسببت في (تبديل المرجعية) فتحول مثل هذا المجيب من تبني (الشريعة الإسلامية) مرجعيةً حاكمة على الحريات يَخضعُ لها النظام السياسي، إلى تبني المرجعية الليبرالية لتكون هي الحاكمة، فحقيقة هذا الجواب مبنية على تبني الفكر الليبرالي القائم على الحرية التي لا تعتد بأي محظورات دينية، فهروبًا من جواب مشكل تبني المجيب تبديل المرجعية!
وهذا يكشف لك عن خطورة الارتهان لمثل هذه المقولات من دون وعي بحقائقها، وما تضمره من لوازم.
أضف على ذلك: أن منطق مقابلة الآخرين بمثله يصح أن يكون معتبرًا في حدود معينة، كما اعتبرتها الشريعة، مقابلة في حدود ما لا يخالف الشرع، وأما جعل ذلك أصلًا كليًا بحد ذاته فهو تفكير موغل في السذاجة والسطحية، ولا تجد أي منظومة فكرية يمكن أن تطبقه، فكل مذهب أو دين أو تيار يمتلك أصولًا وأحكامًا يحافظ عليها، ومن اعتماده عليها يصوغ رؤيته للحياة، ولا يمكن أن ينقض ذلك لمجرد أنه وقع في مأزق المقابلة.
ولهذا فالنظام الغربي حين كفل الحريات، لم يكفلها من باب المقابلة لأحد، ولم يصغ نظامه مراعيًا فيها أحد، إنما انطلق معتمدًا على مرجعيته الفكرية ومصلحته الخاصة، ولو وجد شيئًا من ذلك يضر بمصلحته فإنه سيعيد تشكيل ذلك بناءً عليه، ولن يفكر بتاتًا بطريقة أننا سنعطيهم في مقابل ما يعطوننا، إنما هذا التفكير الهزيل ينشأ من ضعف بعض المسلمين، حين يريد أن يصوغ نظامه السياسي والاجتماعي وفقًا لمرآة الثقافة الغربية، فما دام أنهم يفعلون شيئًا فيجب أن نفعل مثله، بدون أي اعتبار لأي أصول أخرى!
المصدر:
- عبد الله بن صالح العجيري وفهد بن صالح العجلان، زخرف القول: معالجة لأبرز المقولات المؤسسة للانحراف الفكري المعاصر، ص238